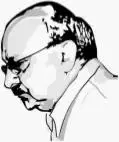مـــــا وراء أرقـــــام موازنـــــة 2008
عبد الحليم فضل الله
قدمت الحكومة اللبنانية مشروع موازنتها للعام المقبل في وقت مبكر، فبدت خطوتها هذه منزوعة السياق، تتوسط المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، وتتجاهل أن الأسابيع القليلة التي تفصلنا عن نهاية المهلة، لا تكفي إطلاقاً لإقرار موازنة سينالها الكثير من الجدل، ولعل هناك من يعمد إلى تكرار تجربة عام 2004، حين أُقرّ مشروع قانون للموازنة لم يبصر النور ولم يضع أية قيود على عمل الحكومة التالية.
وكي يتسنّى وضع هذه الخطوة في إطارها الصحيح نورد الآتي:
أولاً: قدم وزير المال هذه الموازنة على أنها إنجاز جديد لحكومته، إذ التقديرات متفائلة على نحو لا يتناسب البتة مع غموض المرحلة الآتية ورماديتها، والفائض الأولي سيحقق 4.3% من الناتج المحلي القائم أو ما يزيد، في مقابل 2.8% المستهدفة في السيناريو الماكرو اقتصادي الذي تضمنه برنامج لبنان الإصلاحي. هذا «الإنجاز» الافتراضي شجع الوزير على الاستنتاج أن مفاعيل مؤتمر باريس ـــــ3 بدأت تعطي ثمارها، وأن السلطة الحالية خطت على رغم الصعوبات على طريق تحقيق تعهداتها للمانحين، أما هدف الموازنة الرئيسي فهو بحسب واضعيها مواكبة نتائج ذلك المؤتمر وتطبيق التزاماته.
ثانياً: قبل إقرار الموازنة أصدرت الحكومة تقرير الحسابات المالية للدولة اللبنانية خلال الفترة الممتدة من عام 1993 حتى عام 2006. وعلى الرغم من أن قصد السلطة كان تقديم روايتها عن أسباب تضخم الدين العام في وجه الروايات الأخرى، فقد كشف التقرير عن مؤشرات خطيرة، أشدها خطورة أنّ خدمة الدين العام بلغت 43.66% من النفقات وما يوازي 80% من مجموع الدين العام المتراكم، وأنها استنزفت ما يزيد على 73.5% من الإيرادات الإجمالية.
ثالثاً: عبّر وزير الاقتصاد سامي حداد في المؤتمر الصحافي الذي عقده لشرح أسباب ارتفاع الأسعار، على نحو صريح، عن التوجهات الضمنيّة للسلطة، مفصحاً دفعة واحدة عن البدء بإلغاء دعم الصادرات الزراعية، واستثناء الوكالات الحصريّة من قانون المنافسة، وتجميد الروزنامة الزراعية، ومكرراً الرفض الجازم لزيادة الحد الأدنى للأجور.
لنتذكر أن هذه الوقائع تأتي في ظلّ تفرد فريق الموالاة بالحكومة، أي أنّه بات مطلق الحريّة تقريباً في تحويل ميوله الإيديولوجية إلى سياسات فعلية من دون قيود تفرضها الشراكة. مع ذلك فإنّ الإجراءات والسياسات المشار إليها تدور حول المحور العام لسياسات عقد ونصف من الحقبة السوريّة، ما يعني أن انقضاء هذه الحقبة لم يؤد إلى تبدل واسع في السياسات العامة الداخلية للدولة.
في ظل هذا التفرد باتت السلطة قادرة على القيام بما طمحت إليه دائماً، وهو تحميل القطاعات والشرائح الأضعف تبعات الأزمة، فتكون قد توصلت على طريقتها إلى رد نهائي على السؤال العالق: من سيتحمل ثمن الخروج من النفق المالي والاقتصادي؟ إنهم المنتجون وتحديداً القطاعات المشغّلة للأيدي العاملة، في مقابل إعفاء المستوردين الاحتكاريين والمتغذين من ريوع الدين العام من أية مسؤولية، فبات رفع الدعم عن الصادرات الزراعية الزهيد الكلفة متقدماً على معالجة أسباب تراكم خدمة الدين العام التي شكلت حتى الآن أكثر من 31 مليار دولار، وبينما أُعفيت الوكالات الحصرية من تبعات مكافحة الاحتكار، جرى التعامل مع الروزنامة الزراعية على أنها الممارسة الاحتكارية الوحيدة المسبّبة لارتفاع الأسعار.
من الواضح أن الدافع الوحيد من إعداد الموازنة في هذا الوقت، هو إرسال إشارة إلى كبار المانحين، أن بوسعهم الوثوق بقدرة الحكومة على ترجيح كفة الالتزامات الخارجية على الالتزامات الداخليّة، وبالتالي فصل ما تعتبره برنامجاً إصلاحيّاً عن المسارين الاجتماعي والسياسي. وهذا يعني أنّ تقدم لبنان على طريق الحل سيكون مرتهناً لمآل المساومات مع أصحاب النفوذ في الخارج بدلاً من أن يكون حصيلة مساومات داخلية بين قوى الإنتاج وأطرافه، وفئات المستفيدين والمتضررين من السياسات الراهنة، ومن شأن هذا النوع من المساومات الداخلية أن ينشئ عقداً اجتماعيّاً سياسيّاً جديداً، لا يساهم فقط في لجم الأزمة المالية، بل في تصحيح أحد عيوب النظام المزمنة المتمثل في عدم توازن التمثيل الاجتماعي في داخله.
وحتى لو سلمنا جدلاً بضرورة «التفاوض» مع الخارج لتمكين لبنان من تجاوز محنته المالية والاقتصادية، فإن تجربة هذا البلد وغيره من البلدان، تثبت أن فرص نجاح الالتزامات المعطاة للخارج تزيد كلما زاد اعتمادها على توافقات داخلية ناجمة من مساومات داخلية حقيقيّة، وبالتالي فإن تحقيق الحكومة لما تعهدت به في باريس ـــــ3 غير ممكن ما لم تُحوّل هذه التعهدات إلى خيارات محلية تحظى بقبول عام، وما لم تُصاغ من جديد لتعكس على نحو صحيح التنوع الداخلي والطموحات الشعبيّة، فلا يعود من الممكن، مثلاً، رفع الدعم عن الصادرات الزراعية مراعاة لاتفاقية الشراكة الأوروبية، أو إصدار قانون المنافسة للتقيد على نحو استباقي بمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
لن يمر وقت طويل قبل أن يكتشف المانحون والمؤسسات الدولية أن الحلول المرجوّة لا تزال بعيدة المنال، وأن صانعي السياسات الحاليين لا يملكون الوسائل الكافية للوفاء بالتزاماتهم، ولعل المطلوب في الوقت الراهن هو تجميد الخطوات الجذريّة على الصعد المالية والإدارية والاقتصاديّة بانتظار بناء أرضية سياسية صلبة، فمدخل التغيير هو سياسي بامتياز، وأي وفاق وطني لن يكون راسخاً ما لم يشكّل معبراً إلى تداول فعلي للسلطة، لا بين هذه الفئة أو تلك، بل بين برنامج سياسي ــــــ اجتماعي وآخر، ولعل المعارضة اللبنانية قادرة أكثر من غيرها على إنجاز تلك المساومات الكبرى بالنظر إلى تنوعها الداخلي، ولوجود استعداد قوي لديها للوصول إلى حلول وسط قابلة للتحقيق.
قدمت الحكومة اللبنانية مشروع موازنتها للعام المقبل في وقت مبكر، فبدت خطوتها هذه منزوعة السياق، تتوسط المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، وتتجاهل أن الأسابيع القليلة التي تفصلنا عن نهاية المهلة، لا تكفي إطلاقاً لإقرار موازنة سينالها الكثير من الجدل، ولعل هناك من يعمد إلى تكرار تجربة عام 2004، حين أُقرّ مشروع قانون للموازنة لم يبصر النور ولم يضع أية قيود على عمل الحكومة التالية.
وكي يتسنّى وضع هذه الخطوة في إطارها الصحيح نورد الآتي:
أولاً: قدم وزير المال هذه الموازنة على أنها إنجاز جديد لحكومته، إذ التقديرات متفائلة على نحو لا يتناسب البتة مع غموض المرحلة الآتية ورماديتها، والفائض الأولي سيحقق 4.3% من الناتج المحلي القائم أو ما يزيد، في مقابل 2.8% المستهدفة في السيناريو الماكرو اقتصادي الذي تضمنه برنامج لبنان الإصلاحي. هذا «الإنجاز» الافتراضي شجع الوزير على الاستنتاج أن مفاعيل مؤتمر باريس ـــــ3 بدأت تعطي ثمارها، وأن السلطة الحالية خطت على رغم الصعوبات على طريق تحقيق تعهداتها للمانحين، أما هدف الموازنة الرئيسي فهو بحسب واضعيها مواكبة نتائج ذلك المؤتمر وتطبيق التزاماته.
ثانياً: قبل إقرار الموازنة أصدرت الحكومة تقرير الحسابات المالية للدولة اللبنانية خلال الفترة الممتدة من عام 1993 حتى عام 2006. وعلى الرغم من أن قصد السلطة كان تقديم روايتها عن أسباب تضخم الدين العام في وجه الروايات الأخرى، فقد كشف التقرير عن مؤشرات خطيرة، أشدها خطورة أنّ خدمة الدين العام بلغت 43.66% من النفقات وما يوازي 80% من مجموع الدين العام المتراكم، وأنها استنزفت ما يزيد على 73.5% من الإيرادات الإجمالية.
ثالثاً: عبّر وزير الاقتصاد سامي حداد في المؤتمر الصحافي الذي عقده لشرح أسباب ارتفاع الأسعار، على نحو صريح، عن التوجهات الضمنيّة للسلطة، مفصحاً دفعة واحدة عن البدء بإلغاء دعم الصادرات الزراعية، واستثناء الوكالات الحصريّة من قانون المنافسة، وتجميد الروزنامة الزراعية، ومكرراً الرفض الجازم لزيادة الحد الأدنى للأجور.
لنتذكر أن هذه الوقائع تأتي في ظلّ تفرد فريق الموالاة بالحكومة، أي أنّه بات مطلق الحريّة تقريباً في تحويل ميوله الإيديولوجية إلى سياسات فعلية من دون قيود تفرضها الشراكة. مع ذلك فإنّ الإجراءات والسياسات المشار إليها تدور حول المحور العام لسياسات عقد ونصف من الحقبة السوريّة، ما يعني أن انقضاء هذه الحقبة لم يؤد إلى تبدل واسع في السياسات العامة الداخلية للدولة.
في ظل هذا التفرد باتت السلطة قادرة على القيام بما طمحت إليه دائماً، وهو تحميل القطاعات والشرائح الأضعف تبعات الأزمة، فتكون قد توصلت على طريقتها إلى رد نهائي على السؤال العالق: من سيتحمل ثمن الخروج من النفق المالي والاقتصادي؟ إنهم المنتجون وتحديداً القطاعات المشغّلة للأيدي العاملة، في مقابل إعفاء المستوردين الاحتكاريين والمتغذين من ريوع الدين العام من أية مسؤولية، فبات رفع الدعم عن الصادرات الزراعية الزهيد الكلفة متقدماً على معالجة أسباب تراكم خدمة الدين العام التي شكلت حتى الآن أكثر من 31 مليار دولار، وبينما أُعفيت الوكالات الحصرية من تبعات مكافحة الاحتكار، جرى التعامل مع الروزنامة الزراعية على أنها الممارسة الاحتكارية الوحيدة المسبّبة لارتفاع الأسعار.
من الواضح أن الدافع الوحيد من إعداد الموازنة في هذا الوقت، هو إرسال إشارة إلى كبار المانحين، أن بوسعهم الوثوق بقدرة الحكومة على ترجيح كفة الالتزامات الخارجية على الالتزامات الداخليّة، وبالتالي فصل ما تعتبره برنامجاً إصلاحيّاً عن المسارين الاجتماعي والسياسي. وهذا يعني أنّ تقدم لبنان على طريق الحل سيكون مرتهناً لمآل المساومات مع أصحاب النفوذ في الخارج بدلاً من أن يكون حصيلة مساومات داخلية بين قوى الإنتاج وأطرافه، وفئات المستفيدين والمتضررين من السياسات الراهنة، ومن شأن هذا النوع من المساومات الداخلية أن ينشئ عقداً اجتماعيّاً سياسيّاً جديداً، لا يساهم فقط في لجم الأزمة المالية، بل في تصحيح أحد عيوب النظام المزمنة المتمثل في عدم توازن التمثيل الاجتماعي في داخله.
وحتى لو سلمنا جدلاً بضرورة «التفاوض» مع الخارج لتمكين لبنان من تجاوز محنته المالية والاقتصادية، فإن تجربة هذا البلد وغيره من البلدان، تثبت أن فرص نجاح الالتزامات المعطاة للخارج تزيد كلما زاد اعتمادها على توافقات داخلية ناجمة من مساومات داخلية حقيقيّة، وبالتالي فإن تحقيق الحكومة لما تعهدت به في باريس ـــــ3 غير ممكن ما لم تُحوّل هذه التعهدات إلى خيارات محلية تحظى بقبول عام، وما لم تُصاغ من جديد لتعكس على نحو صحيح التنوع الداخلي والطموحات الشعبيّة، فلا يعود من الممكن، مثلاً، رفع الدعم عن الصادرات الزراعية مراعاة لاتفاقية الشراكة الأوروبية، أو إصدار قانون المنافسة للتقيد على نحو استباقي بمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
لن يمر وقت طويل قبل أن يكتشف المانحون والمؤسسات الدولية أن الحلول المرجوّة لا تزال بعيدة المنال، وأن صانعي السياسات الحاليين لا يملكون الوسائل الكافية للوفاء بالتزاماتهم، ولعل المطلوب في الوقت الراهن هو تجميد الخطوات الجذريّة على الصعد المالية والإدارية والاقتصاديّة بانتظار بناء أرضية سياسية صلبة، فمدخل التغيير هو سياسي بامتياز، وأي وفاق وطني لن يكون راسخاً ما لم يشكّل معبراً إلى تداول فعلي للسلطة، لا بين هذه الفئة أو تلك، بل بين برنامج سياسي ــــــ اجتماعي وآخر، ولعل المعارضة اللبنانية قادرة أكثر من غيرها على إنجاز تلك المساومات الكبرى بالنظر إلى تنوعها الداخلي، ولوجود استعداد قوي لديها للوصول إلى حلول وسط قابلة للتحقيق.